الباحث/ الحاجي الوزاني
ينبغي أن نميز بداية بين مفهومي (التربية الإسلامية) و (مادة التربية الإسلامية)، فالمفهوم الأول عام يقصد به “تنمية فكر الإنسان وتنظيم سلوكه وعواطفه على أساس الدين الإسلامي بقصد تحقيق أهداف الإسلام في حياة الفرد والجماعة في كل مجالات الحياة“[1]، أما المفهوم الثاني؛ فهو خاص يحيل على “مادة دراسية تروم تلبية حاجات المتعلم الدينية التي يطلبها منه الشارع، حسب سيرورته النمائية والمعرفية والوجدانية والأخلاقية، وسياقه الاجتماعي والثقافي“[2]، فإذا كانت التربية الإسلامية بمعناها العام ثابتة، وتقوم على مرجعية واحدة هي الإسلام؛ فإن مادة التربية الإسلامية عكس ذلك، فهي متغيرة بتغير السياق الاجتماعي والثقافي، ليس فقط على المستوى المحلي؛ بل على الصعيد العالمي الذي تتحكم فيه القوى الكبرى، وتفرض هيمنتها على باقي دول العالم في إطار نظام عالمي يحاول تنميط العالم على جميع الصعد؛ الثقافية، والاقتصادية، والحقوقية، والسياسية، سواء بالثقافة عن طريق الإعلام بأنواعه المختلفة وأساليبه المتعددة، أو بقوة القانون والمال عن طريق الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليين. وفي هذا السياق نحاول أن نطرح سؤالا إشكاليا يتعلق بالمرجعية، وهو:
ما هي المرجعية التي تستند إليها مادة التربية الإسلامية في المغرب؟
قد يعتقد البعض أن هذا سؤال من باب تحصيل حاصل، فالتربية الإسلامية لها مرجعية واحدة هي الإسلام، لكن الحقيقة في اعتقادنا؛ أن هذا سؤال يشكل اليوم –كما سنرى- أكبر عقبة أمام مادة التربية الإسلامية، ولن تفلح في تحقيق أهدافها ما لم تحسم في المرجعية التي تحدد هويتها، وتحتكم إليها عند الاختلاف، وتبين منهج الاستمداد منها.
أولا: مرجعية مادة التربية الإسلامية:
أشار الميثاق الوطني للتربية والتكوين في المرتكزات الثابتة لإصلاح منظومة التربية والتكوين إلى مجموعة من القيم، وقد لخصها الكتاب الأبيض لاحقا وحددها في:
- قيم العقيدة الإسلامية؛
- قيم الهوية الحضارية ومبادئها الأخلاقية والثقافية؛
- قيم المواطنة؛
- قيم حقوق الإنسان ومبادئها الكونية[3].
وهذه القيم تعكس في الحقيقة تعدد المرجعيات على المستوى القيمي، وهو المجال الأساسي الذي تشتغل عليه مادة التربية الإسلامية، ويمكن تحديد مرجعية هذه القيم في ثلاث مرجعيات؛ مرجعية إسلامية تُمدنا بقيم على مستوى العقيدة، ثم مرجعية محلية تحدد قيم الانتماء الحضاري والثقافي، وأخيرا مرجعية عالمية في مجال المواطنة والحقوق، وأول سؤال يتبادر إلى الذهن هنا، هو: هل الإسلام مرجعية فقط في قيم الاعتقاد ( الإيمان والتوحيد..)، وفقير، أو مناقض لقيم الانتماء الوطني والحقوقي؟ الإجابة طبعا معروفة ومحسومة على المستوى العلمي، ولم أطرح هذا السؤال قصد مناقشته وتحليله، ولكن أردت فقط من خلاله؛ الإشارة إلى أزمة المرجعية لنظام التربية والتكوين التي تنعكس سلبا على منهاج مادة التربية الإسلامية بالخصوص، فالإسلام كما هو معروف؛ عقيدة وشريعة وأخلاق، عبادات ومعاملات، غايته جلب المصالح ودفع المفاسد، ومن أصوله: العرف، والعادة، والمصلحة، وما جرى به العمل، وهو أنموذج في مجال حقوق الإنسان والبيئة وسائر الكائنات الحية، ورغم ذلك تم اختزال قيم الإسلام في مجال العقيدة فقط، وإقصاؤه من باقي المجالات الأخرى، وهو ما يسمحنا باستنتاج ملاحظتين، الأولى؛ أن صاحب القرار التربوي يعتبر الإسلام شأنا خاصا بين المؤمن وربه، والثانية؛ أن أحكامه في مجال التشريع والحقوق متخلفة عن روح العصر وفلسفته.
كانت الإشارة السابقة إلى تعدد المرجعيات تهم النظام التربوي المغربي ككل، ورغم أن مادة التربية الإسلامية جزء من هذا النظام، وينطبق عليها ما ينطبق عليه؛ إلا أن خصوصية المادة تستوجب أن نقف مع وثائقها الرسمية الخاصة لنكون على بينة من الأمر، ومن هذه الوثائق المرجعية الأساسية للمادة؛ وثيقة (منهاج التربية الإسلامية بسلكي التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي الخصوصي والعمومي) الصادرة عن وزارة التربية الوطنية بتاريخ يونيو 2016، في إطار ما سمي بمراجعة مناهج وبرامج مقررات التربية الإسلامية.
بعد أن أشارت هذه الوثيقة إلى المرجعيات السابقة؛ نصت بشكل صريح على مرجعيات منهاج التربية الإسلامية، وحددتها في ثلاث مرجعيات على الشكل الآتي:
- “مرجعية شرعية: حيث تستند دروس التربية الإسلامية إلى:
- خصوصية المعرفة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة؛
- وحدة العقيدة: وفق مقاربة تتجاوز الخلافات الكلامية وتربط المتعلم بالأبعاد العملية للاعتقاد السليم المؤطر لسلوكه وقيمه وتفاعله مع الغير؛
- الثوابت المغربية المتمثلة في إمارة المؤمنين، والمذهب المالكي، والعقيدة الأشعرية، والتصوف السني؛
- مبدأ تأصيل المفاهيم الشرعية انطلاقا من المرجعيات الشرعية.
- مرجعية العلوم الإنسانية: تستند إلى:
- مستجدات الفكر الإنساني في مجال العلوم الإنسانية المنفتحة على قضايا المجتمع، والأسرة، والاقتصاد، والمعاملات المالية، وحقوق الإنسان، والبيئة والمحيط؛
- الانفتاح على الأدبيات الحديثة التي تعالج هذه المفاهيم في مداخل: التزكية، والاقتداء، والاستجابة، والقسط، والحكمة؛
- الانفتاح على فلسفة القيم ومنظومة حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا.
- مرجعية المقاربات البيداغوجية المتمركزة حول المتعلم: تنطلق من مركزية المتعلم وفاعليته، وتؤسس لكل الأنشطة التعلمية المرتبطة بالمادة على إنجاز المتعلم، وتنمية تعلماته ودعمها..”[4]
يهمنا من هذه المرجعيات الأولى والثانية، أما الثالثة فلا تعنينا هنا؛ لأنها مرجعية محايدة تتعلق بطرائق التدريس والتقويم، وإذن، هل تجاوزت وثيقة المنهاج أزمة توحيد المرجعية كما رأيناها في الميثاق لوطني والكتاب الأبيض؛ أم زادت تعميقها وترسيخها؟ وما أثر ذلك على تدريس المادة؟
واضح أن وثيقة المنهاج الخاصة بمادة التربية الإسلامية تبنت بشكل صريح ما ورد في الميثاق الوطني والكتاب الأبيض، ولا تختلف عنهما إلا في العبارة، فالمرجعية الشرعية تضم في الحقيقة مرجعيات وليست مرجعية واحدة، والوثيقة نفسها تشير إلى ذلك عندما صرحت ب “مبدأ تأصيل المفاهيم الشرعية انطلاقا من المرجعيات الشرعية”[5]، غير أن هذه المرجعيات يمكن اختزالها في مرجعيتين، وهما: المرجعية الشرعية المتمثلة في القرآن الكريم والسنة النبوية، ويقابلها في الكتاب الأبيض: قيم العقيدة الإسلامية، ثم مرجعية تراثية يعبر عنها المذهب المالكي، والعقيدة الأشعرية، والتصوف السني، وهو ما أنتجه السلف من فهم على هامش النص القرآني والنبوي وفق سياق معين، ويقابلها في الكتاب الأبيض: قيم الهوية الحضارية ومبادئها الأخلاقية والثقافية، ثم قيم المواطنة، أما المرجعية الثانية، مرجعية العلوم الإنسانية؛ فهي تأكيد كذلك لما ورد في الوثائق السابقة، وبالضبط ما سماه الكتاب الأبيض ب: قيم حقوق الإنسان ومبادئها الكونية، والخلاصة أن هناك ثلاث مرجعيات؛ مرجعية شرعية، ومرجعية تراثية، ثم مرجعية غربية، أي ما أنتجه وينتجه الفكر الغربي في مجال السياسة والاقتصاد والمال والإنسان والمجتمع والفكر بصفة عامة، وهذا التعدد المرجعي يضر بشكل كبير تدريس المادة كما سنرى لاحقا من خلال بعض الأمثلة.
نلاحظ كذلك أن وثيقة المنهاج ميزت بين (المفاهيم الشرعية)، وقضايا ( المجتمع، والأسرة، والاقتصاد، والمعاملات المالية، وحقوق الإنسان، والبيئة والمحيط)، فجعلت تأصيل المفاهيم الشرعية من اختصاص المرجعية الأولى، حيث يجب اعتماد ” مبدأ تأصيل المفاهيم الشرعية انطلاقا من المرجعيات الشرعية”[6]، أما باقي المفاهيم؛ فهي من مهمة المرجعية الثانية، إذ يجب “الانفتاح على الأدبيات الحديثة التي تعالج هذه المفاهيم في مداخل: التزكية، والاقتداء، والاستجابة، والقسط، والحكمة”[7]، وقد نتساءل: ما هي المفاهيم الشرعية؟ وهل الأسرة، والمعاملات المالية، وحقوق الإنسان، مثلا؛ ليست مفاهيم شرعية؟ وهي تساؤلات مشروعة، غير أن الإجابة قد نحصل عليها بسهولة بناء على ما سبق، فالمقصود بالمفاهيم الشرعية؛ هو مفاهيم العقيدة الإسلامية، ثم مفاهيم العبادات بمعناها الاصطلاحي الضيق، وما سوى ذلك؛ فهناك مرجعية أخرى يجب اعتمادها، وحتى إن لم تكن لها الأولوية والغلبة؛ فهي على الأقل تنازع المرجعية الشرعية في تحليل هذه المفاهيم، وهنا نصل إلى السؤال الجوهري، هل هذه المرجعيات الثلاث، المرجعية الشرعية، والمرجعية التراثية، ثم المرجعية الغربية؛ مرجعيات متكاملة أم متناقضة؟
ثانيا: مرجعيات غير منسجمة:
نُذكِّر من جديد أن المرجعية الشرعية نقصد بها القرآن الكريم وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمرجعية التراثية هي جميع الفُهوم التي أنتجها السلف في تفاعلهم مع المرجعية السابقة، ونعني بها بالضبط في هذا السياق؛ ما يعرف بالمغرب بالثوابت، ومنها: المذهب المالكي، والعقيدة الأشعرية، والتصوف السني، وأخيرا المرجعية الغربية، وهي منتجات الفكر الغربي التي يراد فرضها من خلال الاتفاقيات والمواثيق الدولية على أنها قيم كونية، والعلاقة بين هذه المرجعيات هي علاقة تجاوز وتناقض في كثير من الجوانب، فلو جعلنا مثلا المرجعية الشرعية هي الأصل، وحاولنا أن نتبين علاقتها بالمرجعيتين الأخريين؛ لرأينا أن علاقتها بالمرجعية التراثية هي علاقة تجاوز، صحيح أن ما أنتجه الفقهاء المالكية من فقه، وما أبدعه المتكلمون الأشاعرة من كلام، أو ما استقر عليه المتصوفة السنة من سلوك؛ كل ذلك حاول أصحابه استنباطه وتأصيله من القرآن الكريم والسنة النبوية، لكنه مع ذلك يبقى فكرا بشريا مرتبطا بزمانه وسياق نشأته، فكثير من هذا الفكر أصبح متجاوزا في عصرنا الحاضر، أما المرجعية الغربية؛ فعلاقتها بالمرجعية الشرعية هي علاقة تناقض في كثير من الأحيان، ذلك أن المرجعية الشرعية تقوم أساسا على الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ثم العقل الذي يسترشد بالوحي ويحتكم إليه عند الاختلاف، في حين؛ تقوم المرجعية الغربية على نزعة عقلانية مفرطة تحارب كل ما هو سماوي، ولعل الأمثلة التي سنعرضها فيما يلي ستوضح ذلك أكثر.
خلصنا مما سبق؛ أن منهاج مادة التربية الإسلامية يعتمد ثلاث مرجعيات، وأن هذه المرجعيات ليست على سبيل التكامل والتعاون؛ بل هي مختلفة ومتناقضة أحيانا كثيرة، وهو الأمر الذي يشوش ويضر بالمادة، ويحد من فاعليتها وتحقيق مقاصدها، والأمثلة التالية تبين ذلك.
في السنة الأولى من سلك الباكالوريا يدرس المتعلمون في مادة التربية الإسلامية درسا تحت عنوان: (فقه الأسرة: الزواج، الأحكام والمقاصد)، والسؤال هنا؛ ما معنى الزواج؟ هل نحدد مفهومه للمتعلمين انطلاقا من المرجعية الشرعية، أو بناء على المرجعية التراثية؟ فإذا كان الكتاب المدرسي وثيقة للتلميذ وليس ملزما للأستاذ، ووسيلة من وسائل تصريف المنهاج وليس المنهاج نفسه؛ فعلى أي أساس نحدد مفهوم الزواج؟ هل نحتكم إلى الإطار المرجعي؟ إن الإطار المرجعي يكتفي بعبارة عامة تقول: ” الزواج، تعريفه، حكمه، وأركانه، وشروطه”[8]، وإذن لم يبق أمامنا إلا اللجوء إلى مرجعيات المادة المنصوص عليها في وثيقة المنهاج، وهنا مربط الفرس كما يقال؛ لأن مفهوم الزواج يختلف اختلافا جذريا بين المرجعية الشرعية والتراثية.
فمفهوم الزواج انطلاقا من المرجعية الشرعية؛ يجب أن نتوصل إليه من خلال استحضار النصوص الشرعية التي تحدد العلاقة بين الزوج والزوجة، وتبين الغايات والمقاصد، ومن هذه النصوص على سبيل المثال، قوله تعالى: (وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) [الروم:21]، وقوله تعالى أيضا: (هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ) [البقرة:187]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَمْ نَرَ – يُرَ – لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ)[9]، فمن هذه النصوص وغيرها التي وردت في الزواج والعلاقة الزوجية؛ نحدد مفهوم الزواج كما حددته مدونة الأسرة، وهو: “ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين”[10].
أما مفهومه بناء على المرجعية التراثية؛ فهو كما يقول ابن عرفة المالكي (ت 803ه): “عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غيرَ موجب قيمتَها ببينة قبلَه، غيرَ عالم عاقدُها حرمتَها إن حرَّمها الكتابُ على المشهور، أو الإجماعُ على الآخَرِ”[11]، وغني عن البيان أن بين التعريفين بونا شاسعا، فالتعريف الأول يؤسس لعلاقة زوجية تقوم على المشاركة والتعاون والتكامل قصد تحقيق غايات شرعية، فيما التعريف الثاني يختزل هذه العلاقة في بعد واحد، وهو البعد الغريزي للرجل !
وعندما نتجاوز التعريف، ونصل إلى بعض الأحكام المتعلقة بالزواج؛ نصطدم بالمرجعية الغربية التي تشكل إحدى مرجعيات منهاج مادة التربية الإسلامية، ومن ذلك على سبيل المثال؛ تحديد سن الزواج، وتوثيقه في محاكم الأسرة، فمن المعلوم أن الإسلام لم يحدد سنا معينا لصحة عقد الزواج، وزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين، والدخول بها لما بلغت تسعا كما تفيد روايات المحدثين[12]؛ يُتَّخذ دليلا قطعيا في المسألة، كما أن الزواج في الإسلام، وبناء على ما كان عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه يصح بأركانه المعروفة، ويثبت بالإشهاد وقراءة الفاتحة، لكن هذه الأحكام أصبحت متخلفة أمام حقوق الإنسان التي توصف بأنها حقوق كونية، وهو ما يعني مخالفتها ل (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) التي صادق عليها المغرب في 21 يونيو 1993، صحيح أن المغرب تحفظ على بعض الفقرات والمواد، لكنه في التقرير الموجه للأمم المتحدة في سياق تقارير دول الأعضاء، بتاريخ 4 يوليوز 2012؛ أعلن بأن المملكة قامت “بسحب تحفظاتها عن الفقرة الثانية من المادة 9، وعن المادة 16 من الاتفاقية الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة”[13]، وبرفع هذا التحفظ يصبح تحديد سن الزواج وتوثيقه أمرا إلزاميا، جاء في المادة 16 من الاتفاقية المشار إليها أنه “لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها لتحديد سن أدنى للزواج، ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا”[14]، وبسبب هذا التضارب المرجعي لمادة التربية الإسلامية؛ يكرر أساتذتها على مسامع المتعلمين كلما أحسوا بالتناقض والحرج؛ تلك العبارة المتناقضة: (يصح شرعا ولا يصح قضاء) أو (يقع شرعا ولا يقع قضاء) كما في الطلاق الذي أصبح لا يعتد به إلا بعد موافقة القضاء !
ومن الأمثلة أيضا؛ ما نجده في درس: (التصور الإسلامي للحرية) للسنة الثانية باك، فقد اكتفى الإطار المرجعي بالتنصيص على “مفهوم الحرية في التصور الإسلامي، أنواع الحرية ومزاياها في التصور الإسلامي..”[15] لكن الإشكال دائما في التفاصيل كما يقال، فهل حرية الاعتقاد يدخل ضمن مفهوم الحرية في التصور الإسلامي؟
لو اكتفينا بالمرجعية الشرعية، وانطلقنا من المسلمات الأصولية التي تقرر: تقديم القرآن على السنة، والقطعي على الظني، والمتواتر على الآحاد؛ فإن حرية الاعتقاد محفوظة في الإسلام، قال تعالى: (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ..)[البقرة:256]، وقال أيضا: (وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ) [الكهف:29].
لكن لو استحضرنا المرجعية التراثية، وما قررته في هذه المسألة بناء على أحاديث الآحاد المعززة بالإجماع؛ لوجدنا أنفسنا أمام (حد الردة)[16] المناقض لحرية الاعتقاد، ففي صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من بدل دينه فاقتلوه”[17]، ويحكي ابن عبد البر المالكي (ت:463ه) الإجماع فيقول: “فالقتل بالردة على ما ذكرنا لا خلاف بين المسلمين فيه، ولا اختلفت الرواية والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه”[18]
أما المرجعية الغربية فتقرر بشكل صريح حرية الاعتقاد، جاء في (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) الذي صادق عليه المغرب بتاريخ 03 ماي 1979، تحت المادة 18: “لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة”[19]، ونفس الاختلاف والتناقض نجده أيضا في حرية الجسد ومتعلقاته، مثل: حرية الإجهاض، والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.
وهذه مجرد أمثلة تبين الأثر السلبي لتناقض المرجعيات على مستوى تدريس مضامين التربية الإسلامية وتحليلها، وإلا فما يقال عن الزواج والحرية؛ يقال في كثير من المفاهيم والقيم ذات الطبيعة الاجتماعية، والأسرية، والسياسية، والحقوقية، التي يتضمنها المنهاج التربوي للمادة، مثل: العدل، والمساواة، والتسامح، والتعايش، والطلاق، والأهلية، والقوامة، والأسرة، والمسؤولية، والولاية، والشريعة..، فجميع هذه المفاهيم والقيم نجد صعوبة في تدريسها خاصة في ظل منهاج تربوي يحث على مهارات الفهم، والتحليل، والنقد، والإبداع، بدل التلقين والاستهلاك الآلي، فأي مفهوم نبنيه مع التعلمين مثلا؛ للأهلية والمسؤولية والمساواة؟ هل نقول لهم: إن المسؤوليات العامة قاصرة على الرجل وحده، وتحرم على المرأة لأنها غير مؤهلة لذلك؟ أم نتجاهل المرجعية الشرعية والتراثية ونحَكِّم المرجعية الغربية بحكم الواقع؛ فنؤكد المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في تولي جميع المسؤوليات؟ أم نختار الطريق الأسهل؛ وهو الاكتفاء بتعريفات لغوية بناء على نصوص شرعية وفق منهج الوعظ والإرشاد، وإذا طرح المتعلمون أسئلة تقلقهم؛ نتجاهلهم أو نقوم بقمعهم بحجة خروج السؤال عن موضوع الدرس؟ !
خلاصة ونتائج:
لقد تبين لنا من خلال الصفحات السابقة أن النظام التربوي المغربي بشكل عام، ومنهاج مادة التربية الإسلامية بشكل خاص؛ يقوم على ثلاث مرجعيات؛ مرجعية شرعية يمثلها القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، ومرجعية تراثية تتجلى فيما يصطلح عليه بالثوابت المغربية، وهي: المذهب المالكي، والعقيدة الأشعرية، ثم التصوف السني..، ثم مرجعية غربية التي تفرض نفسها على العالم تحت غطاء الكونية، وتستمد مشروعيتها وقوتها القانونية من الاتفاقيات والمواثيق الدولية المصادق عليها.
وقد تبين لنا كذلك من خلال بعض الأمثلة؛ أن هذه المرجعيات لا يجمعها رابط التعاون والتكامل؛ بل بينها علاقة تجاوز وتناقض في كثير من الجوانب، فالمرجعية الشرعية المطلقة ذات المصدر الإلهي؛ تتجاوز كثيرا من الأحكام والتحليلات التراثية المرتبطة بزمانها وسياقها، كما أن المرجعية الغربية القائمة على تقديس العقل وأحكامه؛ تناقض المرجعية الشرعية في كثير من الأحكام والتصورات، وقد نتج عن هذا التعدد المرجعي المختلف والمتناقض؛ آثار سلبية على مستوى تدريس المادة، حيث أصبحت بدون هوية واضحة تحدد أصولها وفصولها ومقاصدها !
إن أكبر تحد يواجه مادة التربية الإسلامية اليوم في نظرنا، ليس ربطها بسوق الشغل كباقي المواد العلمية والتقنية، أو جعلها مجرد وسيلة تتحول وتتلون تبعا للتغيرات المحلية والدولية؛ بل التحدي الأكبر هو تحديد المرجعية، وما لم يحسم صاحب القرار التربوي في تحديد المرجعية، ويتحلى بالشجاعة الكافية في الإعلان عن ذلك بشكل صريح؛ فإن المادة ستظل فاقدة للبوصلة وتسير نحو المجهول، لكن الأمر يبدو أنه في غاية الصعوبة، فالمغرب من جهة، لا يريد أن يفرط في هويته، ومن جهة أخرى؛ لا يريد أن يخسر صورته الحقوقية في سوق المنظمات الدولية، خصوصا وأن اللوبي الحقوقي الذي يمثل المرجعية الغربية في الداخل والخارج قوي جدا، وله أدوات كثيرة لممارسة الضغط، ومن ذلك هذه التوصية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حيث توصي ب “اتخاذ كافة التدابير للقضاء على الصور النمطية السلبية حول المرأة، ومراجعة عميقة للمناهج والبرامج التي تتضمنها، وتشجيع التربية على حقوق الإنسان والمساواة في المدرسة والإعلام، مع إشراك الحركة الحقوقية”[20]والمغرب في تقاريره الدولية في مجال الحقوق دائما يشير إلى استمرارية المملكة في تجديد قوانينها لتلائم حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا، والتي صادق عليها المغرب.
وما نقترحه هنا في الأخير بشكل عام وبعجالة؛ هو تحديد هوية مادة التربية الإسلامية بالمرجعية الشرعية، وجعلها مرجعية تسمو فوق أي مرجعية أخرى، مع التنصيص على الاستئناس فقط بالمرجعية التراثية، والانفتاح على المرجعية الغربية في ضوء هداية الوحي ومقاصده، وكل حكم أو تصور يخالف المرجعية الشرعية لا يلتفت إليه ولا يعمل به، والابتعاد عن التلفيق في قضية مصيرية مثل النظام التربوي، ثم مواصلة الجهود من أجل تجديد تراثنا ليلائم روح العصر في إطار مقاصد الشريعة، وتسخير كافة الأدوات المتاحة، بما فيها التنسيق بين الدول الإسلامية؛ للدفاع عن هذا الاختيار وتسويقه أمام المنظمات الدولية باعتباره إرثا إنسانيا وكونيا ينظر إلى الإنسان والوجود من زاوية مختلفة، وليس من العقل والحكمة إلغاء الاختلاف، وفرض الرأي الواحد الذي يتناقض مع مبدأ الحرية الذي تنادي به هذه المنظومة العالمية نفسها، وفي الأخير؛ أرجو من أصحاب القرار أن يلتفتوا إلى هذه الإشكالية في التعديل الجديد المنتظر، وأن يعملوا بجدية على تجاوزه، وألا يقتصر التعديل على أمور معرفية وشكلية فقط.
مراجع البحث:
- ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – المغرب،1387هـ.
- أبو عبد الله البخاري، الجامع الصحيح المعروف بصحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422هـ.
- أبو عبد الله محمد بن ماجة، سنن ابن ماجة، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية.
- الأمم المتحدة، وثيقة أساسية تشكل الجزء الأول من تقارير الدول الأطراف، المغرب، 4 يوليوز 2012.
- الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 1979.
- الجمعية العامة للأمم المتحدة، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ديسمبر 1966.
- الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التقرير الموازي للتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس المقدمين من طرف الحكومة المغربية بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أكتوبر 2020.
- طه جابر العلواني، إشكالية الردة والمرتدين من صدر الإسلام إلى اليوم، من منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الطبعة الأولى 2006.
- عبد الرحمن النحلاوي، أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع، الطبعة الخامسة والعشرون، دار الفكر، 2007.
- محمد الأنصاري الرصاع، شرح حدود ابن عرفة، تحقيق: محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى 1993.
- وزارة التربية الوطنية المغربية، الكتاب الأبيض، يونيو 2002.
- وزارة التربية الوطنية المغربية، منهاج التربية الإسلامية بسلكي التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي العمومي والخصوصي، يونيو 2016.
- وزارة التربية الوطنية، الإطار المرجعي للسنة الثانية من سلك البكالوريا، مادة التربية الإسلامية، 2016
- وزارة التربية الوطنية، الإطار المرجعي للسنة أولى من سلك البكالوريا، مادة التربية الإسلامية، 2016.
- وزارة العدل والحريات، مدونة الأسرة، صيغة محينة بتاريخ 25 يناير 2016.
[1] عبد الرحمن النحلاوي، أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع، الطبعة الخامسة والعشرون، دار الفكر، 2007، ص: 27
[2] وزارة التربية الوطنية المغربية، منهاج التربية الإسلامية بسلكي التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي العمومي والخصوصي، يونيو 2016، ص: 7
[3] وزارة التربية الوطنية المغربية، الكتاب الأبيض، يونيو 2002،ج 1، ص: 12
[4] وزارة التربية الوطنية، منهاج التربية الإسلامية، مرجع سابق، ص: 5- 6
[5] نفس المرجع، ص: 5
[6] نفس المرجع، ص: 5
[7] نفس المرجع، ص: 6
[8] وزارة التربية الوطنية، الإطار المرجعي للسنة أولى من سلك البكالوريا، مادة التربية الإسلامية، 2016، ص: 5
[9] أبو عبد الله محمد بن ماجة، سنن ابن ماجة، باب: ما جاء في فضل النكاح، تحت رقم: 1847
[10] وزارة العدل والحريات، مدونة الأسرة، صيغة محينة بتاريخ 25 يناير 2016، المادة: 4
[11] محمد الأنصاري الرصاع، شرح حدود ابن عرفة، تحقيق: محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري، دار الغرب الإسلامي، ط 1، 1993، ص: 235
[12] ينظر الحديث في (صحيح البخاري)، باب: تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة.
[13] الأمم المتحدة، وثيقة أساسية تشكل الجزء الأول من تقارير الدول الأطراف، المغرب، 4 يوليوز 2012، ص: 10
[14] الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 1979، من المادة 16.
[15] وزارة التربية الوطنية، الإطار المرجعي للسنة الثانية من سلك البكالوريا، مادة التربية الإسلامية، 2016، ص: 6
[16] ينظر دراسة علمية ومؤصلة في الموضوع، للمرحوم طه جابر العلواني ( إشكالية الردة والمرتدين من صدر الإسلام إلى اليوم)، من منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الطبعة الأولى 2006
[17] أبو عبد الله البخاري، الجامع الصحيح المعروف بصحيح البخاري، باب: المرتد والمرتدة واستتابتهم، تحت رقم: 6922.
[18] ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – المغرب،1387هـ، ج 5، ص: 318
[19] الجمعية العامة للأمم المتحدة، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ديسمبر 1966، من المادة 18.
[20] الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التقرير الموازي للتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس المقدمين من طرف الحكومة المغربية بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أكتوبر 2020، ص: 10

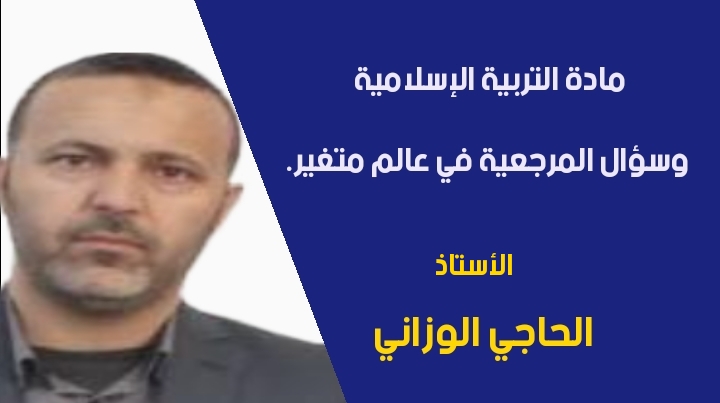
جزاك الله خيرا على هذا الموضوع الجد المهم زادك الله اجتهادا و علما