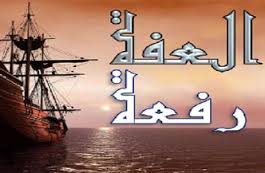بقلم: د. صالح النشاط
تتعدد دلالات قيمة العفة، فهي قيمة أخلاقية؛ تجعل الإنسان يتوقف عند محارم الله، ولا يعتدي عليها، وهي قيمة سلوكية؛ تفرض على الإنسان أن يتبع سلوكا اجتماعيا، غير مخل بحرمة الفضاء الاجتماعي العام للمجتمع، وهي قيمة اعتبارية؛ تساهم في ترتيب الأمور، وإعادة الاعتبار للحقوق والواجبات، وعدم التطاول عما لا يحق ولا يحل للإنسان، وهي قيمة نفسية؛ تطلب من الإنسان أن يتعالى ويترفع عن الاستجابة لرغبات النفس الأمارة بالسوء، والحيلولة دون طغيان شق الفجور على شق التزكية في النفس البشرية، وهي أيضا قيمة مدنية؛ تُعنى بالاهتمام بالشأن العام المشترك بين كل الناس، وتستجيب للحاجات الفطرية للأفراد في أن يتساكنوا ويتعايشوا فيما بينهم، دون اعتداء من أحد على أحد، ولا إخلال بالأمن والنظام والآداب العامة للمجتمع.
إن الحديث عن علاقة العفة بالشأن العام، هو في عمقه، حديث عن موقع المشترك القيمي بين الناس في تدبير شؤونهم العامة، ودرجة حضوره في تصريف السياسات العمومية المؤطرة للحياة العامة.
وعليه، تبرز أهمية الحضور المادي لقيمة العفة في نسج السياسات العمومية، من حيث إظهار القيمة المضافة للعفة في تقويم الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية، وذلك عن طريق إكساب الأفراد مناعة ورقابة ذاتية، تجعلهم يساهمون في تعزيز منظومة القيم والأخلاق المؤثثة لتماسك الفضاء العام المشترك بين عموم الأفراد.
إن تقدير علاقة العفة بالشأن العام، تكمن في استحضار ثلاث مجالات أساسية متكاملة ومتداخلة فيما بينها؛ وهي: مجال الآداب العامة والفضاء القيمي المشترك، ومجال استنبات قيم النزاهة والاستقامة في تدبير الشأن العام، وهناك أيضا، مجال العفة في تدبير المال العام.
أولا: قيمة العفة لتقوية البناء الاخلاقي وحماية الآداب العامة
يعتبر النظام العام، في أي مجتمع إنساني من المجالات المؤطرة بتدخلات القانون الضبطية، والتي تهدف الى حماية الفضاء العام المشترك بين عموم الأفراد، حيث يجتهد كل مجتمع في إدراج تدابير وقائية واحترازية تناسب بناءه الاجتماعي، ومنظومته القيمية، وآدابه العامة.
في المجتمعات الإسلامية، تحضر بقوة منظومة القيم المنتسبة الى الشريعة الإسلامية، على أساس أن هذه الأخيرة تعتبر مصدرا من مصادر التشريع، وبالتالي فخطابها هو خطاب المشرع القانوني، في ضبط المجتمع وتوازنه. وبذلك تكون قيمة العفة، كأحد خلفيات المعيار الأخلاقي، التي يستعين بها المجتمع في فهمه للأحداث والوقائع الاجتماعية بمنظومة القيم والأخلاق والآداب التي تنظم شبكته العلائقية، أفقيا وعموديا، ومن تم يعتبر كل خرق في هذه المنظومة نوعا من الفساد الذي يستهدف نقض أسس هذه الضوابط، حيث يعتبر الفساد من خلال هذا المعيار هو كل سلوك يريد الخروج عن القيم والقواعد الأخلاقية الإنسانية الناظمة للسلوك البشري السوي، ويستهدف تحقيق مصالح ذاتية ضيقة غير منسجمة مع منظومة المجتمع وتكون على حساب المصلحة العامة ومقدرات المجتمع المشتركة.
ففي المغرب، يعتبر القانون الجنائي، من القوانين الزاجرة لكل الاعتداءات على حق المجتمع في الحياة، وهتك حرمة آدابه العامة، فهو يعتبر أن الفضاء العام هو فضاء مشترك لكل الناس، وبالتالي فهو مسيج بسياج الاحترام، حيث اعتبر المشرع الجنائي، على سبيل المثال، أن الإخلال العلني بالحياء بمثابة جريمة، يعاقب عليها، بنص الفصل 483 من القانون الجنائي المغربي، والذي يذهب الى أن من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم”.
وبالتالي، اعتبر المشرع أن قيمة الحياء هي قيمة مجتمعية، وهي ملك لكل أفراد المجتمع ولهم الحق في الحفاظ عليها. ويتحقق الإخلال العلني بالحياء، حينما يعمد أحد الأفراد الى خرق نسق الأخلاق والقيم التي تؤطر حياة الناس، إما في الأماكن العمومية، كالشوارع والحدائق والساحات العمومية، والأزقة والمنتزهات، وغيرها من الفضاءات العمومية، وذلك أمام أفراد، حيث يجتمع في هذه الجريمة الركن المادي، وهو يعني ذلك الفعل المرتكب من قبل الجاني في إخلاله بالحياء، والركن المعنوي المتمثل في حضور القصد والنية في هتك عرض الفضاء العام، إضافة الى توفر عنصر العلانية، أي الخروج بالفعل من دائرة السرية والخاصية الى دائرة العلانية والعمومية.
إن العفة، هي خيار المجتمع في كبح النفس وإلجامها عن الاعتداء على حرمات الأفراد، وذلك بهتك أعراضهم، وخرق حيائهم، إما بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات، وكل ما يمكن أن يحمل في هذا الاتجاه، من قبيل عرض أفلام تخدش الحياء، وتطعن في العفة العامة للمجتمع، أو مشاهد اشهارية تروج للفاحشة وما شابه ذلك، وهي تدخل في إطار السلطة التقديرية الممنوحة للجهاز القضائي في تكييف هذه الأحداث على منوال ما تم التصريح به في الفصل 483 السابق الذكر.
ثانيا: قيمة العفة لتقوية النزاهةوالاستقامة في تدبير الشأن العام
إن إدراج خطاب العفة ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والضوابط القانونية، من شأنه أنه يعزز صرح قيم الشفافية والنزاهة والمصلحة العامة، وهو ما نص عليه الفصل 155 من الدستور المغربي: حينما أكد على أن أعوان المرافق العمومية يمارسون وظائفهم، “وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة”. ان استيعاب هذه المبادئ يحتاج الى تقدير الوازع الذي يتحكم في هؤلاء الأعوان، من حيث حضور الضمير المهني، وقوة القانون، اضافة الى الاحساس بالرقابة الالهية… كل ذلك يعبر عن أحد معاني قيمة الورع، أي عدم اعتدائهم على المصلحة العامة، وعلى حقوق الناس، وحقوق الدولة ومرافقها العامة.
وفي هذا الصدد، أعطى دستور يوليوز 2011، باعتباره مصدر السياسات العمومية، إشارات قوية لدعم توجه المجتمع والدولة في ترشيد ممارسة الشأن العام، ومحاربة كل سياسات الفساد، وكل صور الاختلالات التي يمكن أن تصيب ممارسة الشأن العام، وذلك حينما نص على “الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”، وعمل على دسترتها(الفصل 36) ومنحها حصانة قانونية تؤهلها لممارسة وظائفها ومهامها بكل استقلالية وحرية. على اعتبار أنها ضمير المجتمع الحي في إشاعة قيم النزاهة والشفافية، ومحاصرة الرشوة، وكل أنواع الفساد والعبث في السياسات العمومية.
إن هذه الهيئة الدستورية، وهي تنوب ـ في عمق وظائفها ـ عن المجتمع في ممارسته لِحقه في محاربة الفساد، تتولى بمقتضى الفصل 167 من الدستور مهام “المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة“.
إن سيادة قيمة العفة في دواليب الإدارة العمومية، ومراكز صناعة القرار، يجعل هؤلاء المتصرفين في تدبير الشأن العام، وَقافِـين عند حدود المصلحة العامة، مُـؤثرين مصلحة المجموع على حساب المصلحة الفردية، ومستحضرين رقابة الله تعالى، ويقظة الضمير، وورع القلب، وقبض اليد، على التطاول عما لا يحل ولا يحق.
ثالثا: قيمة العفة في تدبير المال العام
إذا كانت القوانين المنظمة للشأن المالي قد وُجدت لضبط هذا المجال، وتقنين كل السلوكات المالية للمسؤولين، فإن البعض من هؤلاء المسؤولين يتعمدون العبث في المال العام، وذلك عبر بوابة اقتناص الثغرات التي تتيحها هذه القوانين، أو التحايل عليها بإسم هذه القوانين نفسها. حيث تنطوي عمليات الفساد المالي على “الخديعة والتحايل والقفز على القانون وخاصة في حالة عدم التزام الدولة ومؤسساتها بالنظام والقانون” (، فيتم تفسير بعض النصوص القانونية وتحميلها بعض المعاني غير المقبولة، أو التجاوز العمدي لبعض المقتضيات القانونية، أو غض الطرف عن بعض الإجراءات والسلوكات.
وأمام افتراض اللجوء إلى ممارسات من شأنها الإعتداء على حرمة المال العام، من قبيل الاختلاس والتبديد، والسرقة، أصبحت ثقافة المال العام وضرورة حمايته؛ تتأسس في المخيال الاجتماعي للمغاربة، إلى درجة تأثيث هذه الثقافة بمجموعة من الأمثال والقصص والحكايات الشعبية التي تروم داخل مركز انشغالها الاضطلاع بالنقد الاجتماعي اللاذع، من منظور ساخر، وذلك لاستيعاب كل الشرائح الاجتماعية، فأصبحت تصب في خانة التوعية، وتربية حاسة الذوق على التذوق واستخلاص العبر، كما استقبحت حكاياتنا الشعبية الكذب والسرقة، وفساد الأخلاق والكبر والعجرفة والسخرية من الناس، والضحك على أذقانهم، ونزوعات الكيد والحقد والنكاية والتشفي (أحمد العلج، الحكاية الشعبية ودورها في تقويم السلوك، مقالة/ص171)،وهذه بعض التيمات التي جاءت كرد فعل على تيمات أخرى أصبحت تترسخ؛ من قبيل: أن “المال يبدل الحال”، وأن “المال قادر على وضع غلالة تغشي العين العيابة“، و”احصل على المال ولسوف يتفق كل الناس على مناداتك بالسيد النبيل”، وأن “المال يصلح لشراء المسافة الاجتماعية”، وأن “المال السائب يعلم السرقة“. وهكذا من الأمثلة التي صاغها اللسان الشعبي، ودرج عليها السلوك الاجتماعي، فباتت تشكل القاعدة الخلفية لتوقيع العبث بالمال العام.
يتعزز خطاب العفة في موضوع تدبير المال العام، من خلال تقوية الوازع الديني، وردع شق الفجور في النفس البشرية، كما يقول الله تعالى: “ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها،قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها”(سورة الشمس)، لأن النفس البشرية جبلت على حب المال والاستكثار منه، من حله وحرامه، وبالتالي، إدماج مقررات العفة في التربية والمواطنة، والسلوك العام للأفراد، من شأنه الحد من سيل الاعتداءات الموجهة لحرمة المال العام.
نستخلص مما سبق، أن خطاب العفة، يتعين تقويته، من خلال العمل على ادراجه في نسق السياسات العمومية، واستحضاره كقيمة حضارية ومجتمعية، تساهم في تخليق ممارسة الشأن العام، خصوصا، وأن دستور فاتح يوليوز 2011 دعم تدبير السياسات العمومية، بجهاز أخلاقي وقيمي، اضافة الى إرساء آليات الرقابة والمتابعة والتقييم والمحاسبة. وهذا يدفع في اتجاه، تعميق البحث عن مستويات حضور الشريعة الاسلامية بمنظومتها القيمية والأخلاقية، كمصدر من مصادر التشريع، وكدين رسمي للدولة المغربية في رسم معالم السياسات العمومية، وتحديد آليات ممارسة الشأن العام.